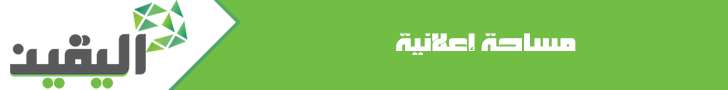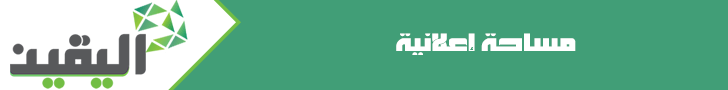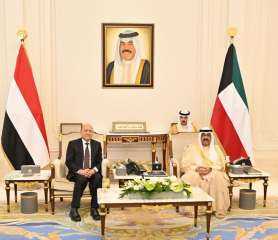خاص قراءة في ”أوركسترا الدرونز”.. سلاح الدول المارقة وأذرعها


إميل أمين - القاهرة - سكاي نيوز عربية
استيقظ العالم على تحدٍ جديد ومخيف لم يكن في الحسبان، بعد أن أضحت الطائرات المسيرة "الدرونز" سلاحا إرهابيا برعاية دول مارقة، أضحت تستخدمه هي وأذرعها لبث الفوضى والقلاقل للمجتمع الدولي، وآخرها الاعتداء على معامل شركة أرامكو السعودية الذي أدان العالم فيه إيران.
الشاهد أن الجواب يقودنا إلى حقيقة مؤكدة، وهي أن هذه النوعية من الطائرات، قد فرضت نفسها في الآونة الأخيرة كسلاح فعال متعدد المهام في المعارك الحربية، ولهذا سعت الدول والجماعات لامتلاكها، لا سيما في توجيه ضربات موجعة للعدو وبتكلفة منخفضة.
طائرات ليست وليدة اليوم
يخطئ من يظن أننا أمام سلاح جديد من حيث التوقيت، فقد ظهرت أول طائرة في إنجلترا عام 1917، فضلاً عن أن التصورات المتعلقة بـ "فرسان الجو"، كانت مواتية للطائرات المأهولة، وإبان حرب فيتنام استخدمت القوات الأميركية عربات طائرة بلا طيار في مهمات استطلاعية.
غير أن النمو التقني أخذ يتسارع بدءاً من السنوات 1970، وكان الجيش الإسرائيلي أحد الفاعلين المبكرين، باعتبار أن مراقبة الأراضي المحتلة تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الأمنية الإسرائيلية.
ولا يعود الفضل في التقدم الساحق، الذي حققته الطائرات بلا طيار منذ بضع سنوات إلى التقنية وحدها، فهذه الانطلاقة، والعهدة هنا على الراوي البروفيسور، توماس هيبلر، الأستاذ المحاضر بمعهد العلوم السياسية في جامعة ليون بفرنسا، تجلت أيضاً بتضافر كثير من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية.
لا سيما الأهمية المتزايدة للصناعات الرقمية، وظهور ما يمكن تسميته بمرحلة "ما بعد الفوردية"، حيث تعتبر حرب العراق في التاريخ الحديث المتأخر، كمرحلتين محددتين حاسمتين، حرب عام 1991 التي تصادفت مع سقوط الاتحاد السوفيتي، والحرب التي شنت في عام 2003.
ولادة من رحم الحرب العالمية الأولى
حين شاهد الأدميرال الأميركي ويليام ستاندلي العام 1932، عرضاً للطائرات البريطانية المسيرة والتي عرفت طريقها إليها عام 1929، وأطلقت عليها اسم "كوين بي"، واستخدمت لغرض التدريب كهدف طائر، وتاليا استخدمت في الحرب العالمية الثانية كصواريخ موجهة، اقترح الأميركي على ضباط البحرية في بلاده تطوير سلاح مشابه، ليتم تسميته بـ"الدرونز"، في إشارة للنحلات العاملات، والتي لا تعمل منفصلة، بمفردها، بل تتبع لقيادة، كما هو الحال لدى الطائرة التي تحتاج إلى مشغل أرضي قريب أو طائرة بطيار ترشدها في الجو.
بعد ذلك بأربعة عقود من الحرب الباردة أبدعت المصانع الأميركية العسكرية في إنتاج نوعيات مختلفة من تلك الطائرات، وبتكلفة قليلة مقارنة بالطائرات المقاتلة الأخرى، فعلى سبيل المثال ثمن الطائرة بلا طيار من طراز "ريبر Reaper M-9"، لا يزيد عن 10.5 مليون دولار، مقابل 150 مليون دولار أميركي للطائرة المطاردة.
أعداد ومستقبل طائرات الدرونز
في تقرير أخير لها الأسابيع القليلة الماضية كانت صحيفة "تليغراف" البريطانية تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات العالمية في صناعة الطائرات المسيرة يصل إلى 127 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه الصناعة ستغير طريقة العيش للملايين من الناس حول العالم، من خلال استهدافها لعدد من المجالات الحيوية في حياة البشر.
والشاهد أن الإنفاق المرتبط باكتساب العتاد وبالبحث في ميدان الآليات التي تطير من غير طيار، يزداد بلا توقف، ولئن كان القسم الأكبر من هذا الإنفاق ينصرف حالياً إلى الاستخدامات العسكرية، فإن الاستخدامات المدنية للطائرة بلا طيار لا تزال تتزايد بسرعة هي الأخرى، وهكذا فإن شركة أمازون للتجارة على الشبكة الرقمية الافتراضية، أعلنت نهاية عام 2013، وسط حملة ذات منسوب هائل من الدعاية والإعلان، عن عزمها استخدام طائرات بلا طيار لتوصيل منتجاتها.
لكن هناك حقولاً أخرى لتطبيق هذه الاستخدامات باتت موجودة، مثل مراقبة الغابات لمكافحة الحرائق، والأمور تجري على نحو يدفع إلى الاعتقاد بأن قطاع الأمن الداخلي يشهد نمواً شديداً، وبات يشكل هو الآخر سوقاً واعدة لصناعة الأجهزة التي يمكن قيادتها عن بعد.
بنية وطريقة عمل الدرونز
تعتمد الطائرات المسيرة في بنائها وهيكلها الخارجي، على معادن خفيفة الوزن والكثافة، حتى تضحى قادرة على التحليق عالياً وبعيداً جداً، كما أن تلك المعادن تمنع حدوث ضجة صوتية في حال استخدامها في الأغراض العسكرية، وعادة ما تكون الطائرات المسيرة مجهزة، بأحدث التقنيات العسكرية، لا سيما الكاميرات التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء، عطفاً على أجهزة الـGPS، وكذلك أجهزة الليزر، والطائرة برمتها يتم التحكم فيها عن بعد من خلال "جي إس سي"، أي قمرة القيادة الأرضية، حيث الأدمغة البشرية التي تعرف فيما تسخر هذه الطائرات.
وعندما يتم تشغيل الدرونز، فإن الأمر يبدأ باختيار نظام الملاحة العالمي، وفي حال التأكد من نجاحه تعطي إشارة استعدادها للإقلاع، وتقوم بتحديد موقعها ليكون نقطة العودة عقب إنتهاء الرحلة.
ولعل السؤال كيف لمثل هذه الطائرات أن تجد طريقها في رحلة العودة؟
هنا نحن أمام ثلاثة طرق للعودة من الجو، أولها أن يتم ذلك بواسطة الطيار الأرضي، في قمرة القيادة، أو تقوم الطائرة بالعودة آلياً عندما تنخفض البطارية، أو عندما تتعرض لمشكلة تفقدها الاتصال بقمرة القيادة الأرضية، فتبدأ في العودة إلى النقطة، التي تم تحديدها عند الإقلاع.
أميركا وصندوق بنادورة الدرونز
أحد الأسئلة المثيرة ونحن نتحدث عن الدرونز: "هل فتحت أميركا للعالم صندوق بنادورة الشرور"؟
الثابت أنه في العام 1991 وضعت القوات الأميركية قيد الممارسة وعلى نطاق واسع، التجديدات والابتكارات التقنية التي بدأت تجربتها تتوالى منذ حرب فيتنام، بما في ذلك "القنابل الذكية"، ومنظومات التوجيه بالأقمار الاصطناعية، والأجرام الفضائية.
والمؤكد أنه منذ زوال الاتحاد السوفيتي، انتقل أفق أو منظور الحرب ضد قوة عظمي إلى المرتبة الثانية، وبات يبدو أن المهمات العسكرية ستقتصر بعد الآن على تدخلات محدودة ومحصورة نسبياً، وعلى مسارح كثيراً ما تكون بعيدة، وضد قوى أدنى قوة، وأقل تجهيزاً، وهكذا ولدت فكرة "الحرب ما –بعد- البطولية"، التي لا تتسبب بموت أي جندي في القتال من جانب قوات التدخل، ولا تتسبب إلا بأقل قدر ممكن من الخسائر بين المدنيين.
في هذا السياق أضحت الطائرات من غير طيار، التي كانت في أوج نموها، على الصعيد التقني حينذاك، تبدو للمسؤولين السياسيين والعسكريين، حلاً مناسباً يقع على تقاطع منطق "عدد الموتى صفر"، ومنطق الحرب الشبكية الأميركية ، التي تجنب الأميركيين الدماء في المواجهات العسكرية القادمة خلال سعي الإمبراطورية للهيمنة على مقدرات العالم.
حروب الدرونز على الأرض
يمكن القطع بأن واشنطن هي من افتتح أوركسترا حروب الدرونز، الأمر الذي يتناوله موقع "التحقيقات الشفافة" البريطاني بوضوح، والذي يشير إلى أن القوات المسلحة الأميركية قد ذهبت لاستقدام طائرات مسيرة بغية تصوير مواقع عسكرية في الصين أو فيتنام الشمالية، عوضاً عن الطائرات التقليدية، التي قد تتعرض للضرب ومن ثم أسر الطيار.
على أن مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر من عام 2001، وبعد الاعتداء على نيويورك وواشنطن من قبل تنظيم القاعدة، بحسب الاتهام الأميركي، فإن واشنطن اعتبرت "الدرونز" سلاحها المفضل للاقتصاص من الإرهاب والإرهابيين، وملاحقة قادة تنظيم القاعدة، والسعي للقضاء بشكل كامل على تجمعات عناصر القاعدة في باكستان وأفغانستان واليمن وليبيا والصومال.
ولعل القراءات الإحصائية لولايتي الرئيس جورج بوش الابن، تظهران قيام القيادة الأميركية بشن 57 ضربة باستخدام الدرونز ضد قيادات وعناصر "القاعدة"، بينما تضاعف ذلك الرقم 10 مرات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ليضحي 563 ضربة على فترتين رئاسيتين.
حصدت الدرونز لا سيما في أفغانستان آلاف القتلى من عناصر القاعدة، غير أن الكارثة تمثلت كذلك في آلاف آخرين من المدنيين قضوا من دون ذنب، وفي وسط زحام الضربات، ما جعل الرئيس الأفغاني السابق حميد كرازي يطالب عام 2012 بإيقاف نشاط الدرونز على أرض بلاده، بعد وقوع 30 ضربة ذلك العام على منازل مدنيين.
تركيا والدرونز الهدام عالميا
يمكن للمرء أن يتقبل فكرة نشوء وارتقاء دول كبرى أخرى مثل الصين وروسيا، تنافس الولايات المتحدة في إنتاج الطائرات المسيرة، ومنطق موسكو وبكين هنا في بيع تلك الأسلحة الحديثة للعالم، غير ذاك الذي يحكم واشنطن، حيث القيود المرتبطة ببيع السلاح إلى الجماعات المعارضة، أو الحكومات المارقة، وحيث قضية حقوق الإنسان لا تشكل معضلة كبرى، إذ يمكن تجاوزها بسهولة ويسر شديدين.
غير أنه حين تضحى تركيا سادس دولة في العالم تصنع وتطور، بل وتصدر طائرات الدرونز العسكرية، فإن هناك خلل جوهري يتوجب النظر إليه، ومخاطر جمة ينبغي التنبه لها.
انتقلت تركيا مؤخراً من مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج محركات "الدرونز" إلى تصدير تلك المحركات للخارج، ودخول باب المنافسة العالمية في هذا المجال.
هنا يضحى السؤال القاتل "إلى يد من يمكن أن تصل هذه الطائرات المسيرة في نسختها الفتاكة"؟
لا يحتاج الجواب إلى الكثير من إجهاد الذهن، فتركيا عرفت خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لا سيما سنوات ما عرف بـ "الربيع العربي" المغشوش، بأنها ممر ومستقر جماعات الإسلام السياسي، على اختلاف أنواعها وألوانها، بدءاً من تلك التي تقدم ذاتها للعالم بوصفها صاحبة مشروع سياسي للأمة، كالتنظيم الدولي للإخوان وصولاً إلى الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش ومن لف لفه.
الدرونز في يد الدواعش
هل زودت تركيا الدواعش بالمسيرات أم أنها وفرت لبعض عقول داعش مكاناً وأجواءً ملائمة للقيام بتجاربهم التي قادت إلى امتلاكهم تلك الأسلحة الفتاكة؟.
المعروف أنه في صيف العام 2014، نشر تنظيم داعش فيديو دعائياً يظهر مدى تمدد رقعة سيطرته في العراق، حيث استخدم في مقدمة الفيديو مشاهد التقطت بطائرات الدرونز لإضفاء لمحة سينمائية على دعايته، وإن لم يتوقف الأمر عند هذا النحو فقط .. ما الذي جرى؟
ربما تكون الإجابة لدى صحيفة "التليغراف" البريطانية، والتي أشارت إلى أن البنتاغون قد طلب من الكونغرس تمويلاً بملايين الدولارات من أجل التصدي لدرونز الدواعش.
فيما أفادت صحيفة "ديلي بيست" نقلاً عن وسائل مسربة للمخابرات المركزية الأميركية (CIA) بأن تنظيم داعش في الموصل قد أولى اهتماماً لسلاح الدرونز لدرجة إنشائه لواء عسكرياً خاصاً لتطويرها منذ عام 2013.
لم يكن داعش هو التنظيم الإرهابي الوحيد الذي شاغبته وشاغلته فتنة الدرونز، فقد سبقه تنظيم القاعدة، وبتنسيق مؤكد لرجال الاستخبارات مع إيران وتركيا، وبات من المعتاد أن تصدر تصريحات من الجيش الروسي وبيانات تشير إلى أن وحداته العسكرية تصدت لعشرات الضربات الصاروخية التي تشن عليها بواسطة الدرونز التي يطلقها عليهم رجال من تنظيم القاعدة، لا سيما في قاعدة "حميميم" العسكرية شمال سوريا.
إيران ودرونز الوكلاء والميليشيات
لم يكن لإيران وهي تعلن العداء العلني لكافة جيرانها في منطقة الخليج العربي أن تقف مكتوفة الأيدي، أو بعيدة عن مجال إنتاج الطائرات المسيرة، وهي التي تمضي قدماً في سياق برنامج نووي، وآخر صاروخي، وكلاهما مهدد لأمن وأمان العالم دفعة واحدة، وليس لمنطقة الخليج فقط.
منذ حرب الخليج الأولى في ثمانينات القرن الماضي، أخذت إيران في تطوير طائرات مسيرة من نوع "مهاجر"، وخلال ثلاثة عقود كانت قد أنتجت أنواعاً مختلفة منها، لا سيما "أبابيل"، تلك الطائرة التي زودت بها وكلاءها من الميلشيات في منطقة الخليج كالحوثيين في اليمن، كما أرسلتها إلى أذرعها في لبنان حيث مليشيات حزب الله في الجنوب، وإلى حماس في غزة، لتصل إلى كتائب عز الدين القسام التي هاجمت بها القوات الإسرائيلية صيف 2014، خلال حرب غزة الثالثة.
استغل الإيرانيون وجودهم في سوريا، لفتح طريق برية لإيصال الطائرات المسيرة من إيران لسوريا، ومنها إلى بقية الحلفاء في المنطقة بالقرب من إسرائيل.
وفي توقيت مواكب كان العالم على موعد مع المسيرات الإيرانية المتجهة من الأماكن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية، وشنت بالفعل عدداً من الغارات على البنية التحتية النفطية السعودية، إحداها على خط أنابيب النفط الخام بين الشرق والغرب ذي الأهمية القصوى، وأخرى على مرفق حيوي في عمق الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، وذلك قبل الهجوم الأشرس والأخطر، الذي تعرضت له مصافي أرامكو قبل نحو ثلاثة أسابيع تقريباً، والذي تشير كافة الأدلة على أن مسيرات إيران وراءه سواء انطلقت من اليمن أو العراق أو من قلب إيران عينها.
في التصدي للدرونز الضار
هل بات الدرونز الإرهابي قدر مقدور في زمن منظور، بمعنى أنه ما من طريقة لمواجهة خطره، وصد إرهابه، وإبعاد مآسيه عن الآمنين والأبرياء؟
الجواب هنا ربما يحتاج إلى قراءة تحليلية وتفكيكية خاصة، سيما وأن التصدي لمثل هذه الطائرات يحتاج إلى القفز على تحديات عديدة، منها أن صغر حجمها يجعلها غير قابلة للرصد بالعين المجردة، لا سيما من المسافات القريبة، كما أنها في الوقت عينه غير قابلة للكشف بشكل عام بواسطة رادارات الدفاع الجوي، تلك المصممة أصلاً للكشف عن الطائرات الكبيرة والسريعة.
في دراسة حديثه لـ "منتدى فكرة"، عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، يثير الباحث أرثر ميشال هذه الإشكالية المعقدة، ويلفت إلى أن البنتاغون في العام 2017 أجرى مناورة للتدريب على التصدي للطائرات بدون طيار دامت خمسة أيام، وقامت مجموعة متنوعة من شركات تصنيع الأنظمة الدفاعية المتمرسة منها والناشئة، باختيار ما تنتجه من الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار، أو المضادة للطائرات المسيرة، على طائرات بدون طيار تعمل على مسافة 200 متر تقريباً .. ماذا كانت النتيجة.
لاحقاً وبعد المناورات أفاد المنظمون، بأن تلك الطائرات كانت "مقاومة جداً للضرر"، واستنتجوا أن غالبية الأنظمة المضادة لها بحاجة إلى مزيد من التطوير، وقد فشلت هذه الأنظمة الجوية المضادة للطائرات بدون طيار، أو المضادة للطائرات المسيرة في العمليات الواقعية أيضاً، إذ بدا مثلاً أن عدداً من الطائرات بدون طيار قد تخطى الأنظمة المضادة الثمانية التي نشرها في أولمبياد ريو عام 2016، من بينها تلك التي استخدمت خلال مراسيم الافتتاح.
الدرونز وانتكاسة الحريات الخاصة
تحتمل القراءة في إشكالية الدرونز في الحال، واستشرافات مستقبلها، ملفات وأبحاث ودراسات قائمة بعينها، سيما وإن تكاثر أنواعها وانتشارها يشكل خطراً جسيماً حال وصولها –وقد وصلت بالفعل- إلى فاعلين غير دوليين، لا سيما من الجماعات الإرهابية والمارقة.
غير أن البروفيسور توماس هيبلر المشار إليه سلفاً، يضعنا بنوع خاص بجانب المسائل الأمنية، أمام عدد من الإشكاليات القانونية والأخلاقية، كما تشهد على ذلك السجالات حول الإعدامات التي تنفذ بمنأى عن العدالة والقضاء.
ثم إن هذه القضايا والأهداف، تصبح أشد أهمية مع تنامي هذه التكنولوجيات الجديدة بمنأى عن كل رقابة ديمقراطية.
عطفاً على ما تقدم فإن المسيرات تعمق من ظاهرة تسليم الإنسان الآلي مهمات القمع، بحيث أن الإنسان الحقيقي بات بصدد التحول إلى مجرد ملحق مضاف إلى أنظمة تقنية.
هناك جزء مثير ومخيف، فالمسيرات وكما يمكن استخدامها في الهجمات الإرهابية، يمكنها أيضاً أن تشارك في إطار "مهمات المراقبة والاستخبارات في الوسط المدني الحبيس"، ما يعني أنها أداة من أدوات تقليص مساحة الحريات الخاصة للبشر، أولئك الذين يضحون في عالم "جورج أوريل" وروايته "1984"، حيث الأخ الأكبر، يرصد بالصوت والصورة، كل همسة، وكل كلمة براً وبحراً وجواً.
هل ظاهرة الدرونز أكثر إشكالية من مجرد استخداماتها العسكرية إذن؟
أغلب الظن أن ذلك كذلك قولاً وفعلاً، والمؤكد أنها إفراز من إفرازات الذكاء الاصطناعي، والذي سيغير من شكل عالمنا المعاصر، وعساه كان يحوله أو يبدله إلى الأفضل، من دون الحاجة إلى هجمات إرهابية أو اختزالات من الحرية الشخصية.